- علي الصلابي
مرّ نبي الله يوسف عليه السلام في حياته بابتلاءات كثيرة، ككيد إخوته به، وإلقائه في غيابة الجب، ثم بيعه كما تباع العبيد وتشترى، ثم محنة امرأة العزيز والسجن بعدها، إلى أن جاءت الفتوح من الله الكريم، فخرج من السجن معززاً مكرّماً إلى أن صار أميناً على خزائن أرض مصر، ولا يؤخذ في مصر قرار، أو يُقدَم على أمر إلا بمشورته والرجوع إليه عليه الصلاة والسلام.
ويعد امتحان أخذ يوسف عليه السلام وبيعه كالعبيد والرقيق من أكثر المراحل خطراً وأشدها صعوبة وأقساها امتحاناً، في حياته عليه الصلاة والسلام، فلئن ابتلي مع إخوته بتشريده الأسري فلقد كان ابتلاؤه في هذه المرحلة من حياته للجانب الروحي والخلقي نتيجة الجمال الخَلْقي والخُلُقي.
قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَ الّذي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لَا يَعْلَمُونَ﴾:
وقد اشتمل هذا النصّ على تحديد مكان القصّة (من مصر)، وأنّ المشتري له من ذوي المكانة بدليل قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21]، وأنّ يوسف كان إذ ذاك صبيّاً بدليل قوله تعالى: ﴿ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [يوسف: 21]، ففي ذكر قول المشتري، في قوله تعالى: ﴿وقال﴾ عناية بإظهار ما تحدث به لنعرف وندرك ما نتفوّه به، لأنّ لذلك شأناً في تفسير الأحداث ومعرفة بعض ما يمكن أن يخص تعريف هذا القائل بالاسم الموصول مع صلته: ﴿الّذي اشتراه﴾ لا يظهر فيها تحديد دقيق لشخصيّة هذا المشتري ولا لمكانته، وإن كان ذلك سيظهر من خلال إشارة أخرى في النص، وكل ما دلت عليه الجملة هو أن هذا القول هو ممن اشتراه، وهذا يشعر بحاجته لمثل هذا الصبي، وعنايته بأمره كما تنبئ عنه مقالته.
ثمّ إن تعليل مطلبه بقوله: ﴿أن ينفعنا﴾، فيه كشف لحجم الحاجة إلى الولد عنده وعند زوجه، ذلك أن كلمة: (النفع) لا تعني النفع المادي المعهود من الولد، لأن القائل من ذوي الهيئات والمكانة على ما تدل عليه أحداث القصّة القادمة، فعلم من هذا أن النفع هنا خاص، وهو ما تتعلق نفوس الزوجين من الولد، وهذه فطرة جعلها الله سبحانه سبباً للتناسل والبقاء، إلّا أن هذه الدلالة تزاحمها دلالةٌ التعليل الآخر: ﴿أو نتخذه ولداً﴾ علّة ثانية، قد تكون هي المقصودة؛ لأنها المناسبة لوصفها الاجتماعي والأسري، خصوصاً أن ﴿نتخذ﴾، فيها من دلالة الاتخاذ والاصطفاء والاختيار والاهتمام ما ليس في غيرها، ذلك أنّ مادة الاتخاذ في القرآن تشعر بهذا.
وفي تحديد صفة المتخذ بـ(ولداً) كشْف أوسع لذلك الاصطفاء وتلك الحاجة، واختيار لفظة الولد على الابن مثلاً، لأن الولد أشمل وأعم من حيث الجنس ومن حيث العدد، يقول الراغب: الولد: المولود. يقال للواحد والجمع والصغير والكبير، ويقال للمتبنَّى ولد، قال أبو الحسن: الولد: الابن، والابنة. والوُلْد هم: الأهل والولد. (مفردات غريب القرآن الكريم، الراغب الأصفهاني ص883).
– ﴿أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾: أي: نتبناه ونجعله ولداً لنا. ويبدو أن عزيز مصر كان لا يولد له. كما يظهر أن التبني واستلحاق إنسان بنسب إنسان آخر كان أمراً شائعاً في المجتمعات القديمة وعند العرب قبل الإسلام، حتّى إن النبيّ ﷺ تبنى زيد بن حارثة، وألحقه بنسبه الشريف قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، فكان يُدعى: زيد بن محمّد، حتّى أنزل الله تعالى على نبيه تحريم ذلك بقوله الكريم: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)﴾ [الأحزاب: 4 – 6]، فرجع النبيّ ﷺ عن ذلك وحرم أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، وقال: ” ليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلّا كفر”.
– ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾: وبعد انتهاء عزيز مصر من كلامه جاء حكم الله سبحانه المبيّن حكمته جلّت قدرته من هذه الأحداث وتسلسلها. وقد جاء هذا الحكم الإلهي بأسلوب مختلف عمّا كان عليه حال يوسف من قبل، فمحتوى هذا الحكم هو التمكين والتعليم والغلبة، وهذه مرحلة جديدة في حياة يوسف عليه السلام، وإذا تأملنا النص وجدنا في أوّل الآية أسلوب التشبيه بما هو معتاد في القرآن.
ومما يلفت النظر: الحالة الجديدة من حياة يوسف عليه السلام بمجيء مادة التمكين: ﴿مكنّا﴾، وما فيها من دلائل النصرة، إذ إن التمكين مأخوذ من المكان، ومعنى ﴿مكنّا﴾: جعلناه في المكان، وهذا يؤول إلى الاستقرار والبقاء مع قوة وقدرة، ولعلّ هذا تعويض لحالة التنقل والبيع الّتي مرّ بها يوسف عليه السلام.
– ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾: كتعبير الرؤى ومعرفة حقائق الأمور. ويأتي العطاء الثاني بعد التمكين معطوفاً بالواو: ﴿ولنعلمه﴾، والنص على التعليم لأنّه أحد صور التمكين، خصوصاً إذا ارتبط بعلم خفي يحتاجه النّاس، مثل تأويل الأحاديث، ومما يدلّ على خفاء العلم ودقته هنا كلمة: ﴿تأويل﴾ دون: (تفسير) مثلاً، ذلك أنّ تعبير الرؤيا أمر يحتاج إلى علم خاص، وفيه إلهام من الله للمعبّر، وهو علم لأن الله سبحانه قال: ﴿ولنعلمه﴾، وفي دخول: (من) في قوله تعالى: ﴿من تأويل﴾ دلالة على أنّه علم عظيم واسع، وما أعطيه يوسف هو بعض هذا العلم. ومجيء كلمة: ﴿الأحاديث﴾ دون كلمة: (الرؤيا) قد يكون فيه إشارة إلى أنّ الرؤيا في ذلك العهد مما يهتم به النّاس ويتحدثون به ويتناقلونه. ومن الملحوظ أن هذا المعنى ذكر أولاً في السّورة بلفظ الرؤيا: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ﴾ [يوسف: 5]، ثمّ ذكر بلفظ الفتوى: في قوله: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الّذي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [يوسف: 41]، ثمّ ذكر في لفظ الأضغاث في قوله: ﴿قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾ [يوسف: 44]، وهذا التنوع له دلالته بحسب الموقع الّذي ذكر فيه والقائل الّذي صدر عنه، وهو ما ينبغي العناية به.
ومما لا شك فيه، أنَّ تمام النعمة بنعمة النبوّة ونعمة الحكمة الدنيوية، والاجتباء الأخروي مع المجد الدنيوي، وبناءً على ذلك، فإنّ تأويل الأحاديث يشمل ما يسمى في عصرنا الحاضر بالتحليل السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، وبذلك يتحقق الاقتداء الكامل؛ لأنّ تأويل يوسف عليه السلام للأحاديث إذا حمل على النبوّة فلا قدوة فيها، لأنها غير مكتسبة، ولكن إذا شمل التّحليل العقلي القائم على الحكمة؛ فإن ذلك هو محلّ الاقتداء.
لقد أصبح يوسف في بيت العزيز ممكناً له، وتوفرت له فيه أسباب الراحة والرغد وهناءة العيش والنعيم، ثمّ كلّ أسباب التعليم، وصار قريباً من مراكز صناعة القرار في مصر، وتعلّم الشيء الكثير من أحوال البلد وعقليّة الإدارة والتركيبة السياسية، والاجتماعية والإمكانات الاقتصادية، واطّلع على تفاصيل المجتمع المصري، والمملكة المصرية في ذلك الوقت، ما ساعده بعد توفيق الله فيما بعد على اتخاذ القرارات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية الصحيحة الّتي ساهمت في إنقاذ مصر وما حولها من كوارث شديدة الخطورة.
– ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ وفيه ملمح آخر من ملامح التمكين ليوسف عليه السلام، وإن كان النظم في هذا الحكم جاء مغايراً عمّا سبقه، فقد جاء بالسياق الاسميّ، ولم يرد بالسياق الفعليّ، وإلا لقيل: (ويغلب الله). وذلك لكون هذا الحكم كالقانون الّذي لا يتبدّل مع يوسف ومع غيره، والجملة الاسميّة أكثر دلالة على الثبات من الجملة الفعليّة، خصوصاً إذا كان الخبر اسماً، كما هو الحال.
– ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾: فلا يستعصي عليه أمر، ولا يمانعه شيء، وهو القائل: ﴿إنّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: 82]. أو: والله متولٍّ يوسف لا يكله إلى غيره، وقد أرادوا هلاكه، وأراد الله تعالى سلامته ونجاته، فكان ما أراده سبحانه. فلا راد لقضائه، ولا غالب لمشيئته. ولمّا كان هذا الأمر، وهو غلبة الله على أمره ووقوع ما قدّره سبحانه، مما يغفل عنه النّاس، أو يعقلون ضد مقتضاه؛ جاء الاستدراك المبيّن لحال النّاس المخالف لذلك:
– ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لَا يَعْلَمُونَ﴾: لا يعلمون أنّه تعالى غالب على أمره، بل يأخذون بظواهر الأمور، كما استدلّ إخوة يوسف بإبعاده على أن يخلو لهم وجه أبيهم ويكونوا من بعده قوماً صالحين، ويقابل الأكثر في هذا المقام يعقوب عليه السلام؛ فقد كان يعلم أنّ الله غالب على أمره، وأقواله صريحة في الدلالة على علمه ما تقدم منها وما تأخر في هذه القصّة، ولكن علمه كلي إجمالي لا يحيط بتفصيل الجزئيات المخبوءة في مطاوي الأقدار.
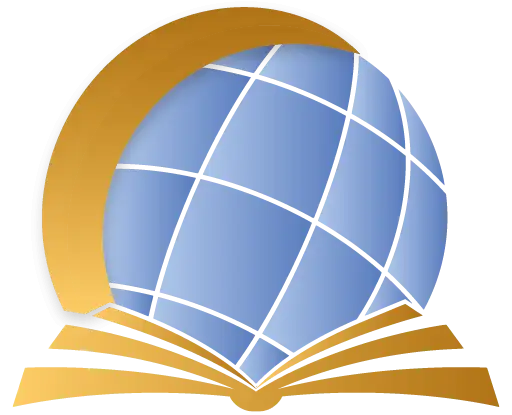


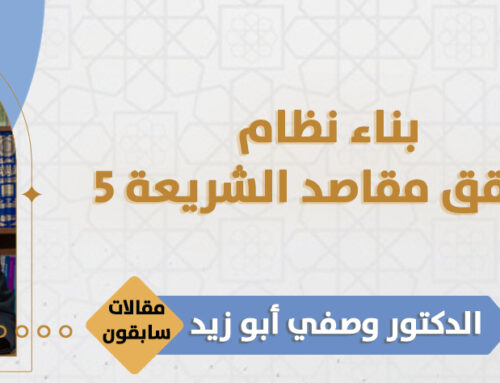








Leave A Comment