د. عطية عدلان
لأسباب تتعلق جميعُها بالمنهجية العلمية بدأت الحضارة المعاصرة تعاني من تقلصات وتشنجات واضرابات حادّة في منطقة اليقين العلميّ، حتى صارت “اللاأدرية” اتجاهًا واسع الامتداد، ولم تعد الأسئلة الكبرى -كسؤال الغاية من الوجود- تكفي لملء الفراغ الذي يفرّ منه العقل الغربيّ على الدوام؛ بسبب انزياح كثير من المسائل الكونية الكلية التي لا يوجد لها تفسير إلى ذلك الفراغ المفزع الذي بدا كثقب أَسْوَد يتربص بكل ما يدور حوله من أجرام وأفلاك؛ فما هي خلفيات الأزمة؟
لماذا كان اليقين العلميّ غاية قرآنية؟
كثيرة هي الآيات القرآنية التي ذكرت اليقين فجعلته شرطًا للانتفاع بالآيات والبينات: {قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، {هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}؛ بما يعني أنّ اليقين طبيعة إنسانية سويّة تستقيم مع الهدى ويستقيم الهدى معها؛ لذلك جاءت إلى جوار تلك الآيات آياتٌ تجعل اكتساب اليقين غاية لتدبير الأمر وتفصيل الآيات: {وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}، {اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ}؛ فصار اليقين شرطًا لنجاح الدعاة والهداة: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ}، أمّا عدم اليقين فَخِفَّةٌ وطيش: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ}.
وعلى نهج القرآن مضت السنّة النبوية، حتى لقد استطاع العلماء باستقراء الأحاديث أن يخرجوا منها بقاعدة فقهية وقانونية راسية هي “اليقين لا يزول بالشك”، وفرعوا عليها قواعد عملية مثل: “الأصل بقاء ما كان على ما كان”.
فساد المنطلقات وأثره في الانحراف المنهجيّ
ومن أجل بناء اليقين والبناء عليه؛ أعطى القرآن الدفعة الأولى لمسيرة المنهج التجريبيّ، القائم على الملاحظة العلمية المنضبطة، وعلى المشاهدات الاستقرائية، وعلى إعمال الحواسّ مع العقل، فانطلقت المسيرة العلمية في ظل الحضارة الإسلامية ما شاء الله لها حسبما تهيأت لها الظروف، ثم جاء العصر الحديث لينطلق العلماء بالمنهجية ذاتها؛ وعلى الرغم من عظمة الأثر الذي خَلَّفَهُ “فرنسيس بيكون” في الحياة العلمية الأوربية؛ بنقض المنهج الأرسطاطاليسي، وإقامة المنهج التجريبيّ على أنقاضه، وعلى الرغم -كذلك- من حراسته لهذا المنهج بجملة كبيرة من المحددات المنهجية التي أرساها حول المنهج في “الأورجانون الجديد”، على الرغم من ذلك كله انحرفت أوربا بهذا المنهج عن مساره، وزاغت عن المنهج العلميّ التجريبيّ ذاته.
وتلخصت أسباب هذا الانحراف في جملة من الأوهام الفكرية والأصنام المنهجية التي يكمن وراءها الدافع الكبير والهوى الجامح الذي كان يجتاح أوربا ولا يزال، فأوربا -التي رزحت دهرًا طويلا تحت سلطان الكنيسة، بعسفها وقهرها واستبدادها وفسادها- انطلقت منذ عصر النهضة في الاتجاه المعاكس تمامًا؛ فبعد أن كانت الحياة الدنيا رجسًا يجب التطهر منه صارت هي وحدها مصدر السعادة لكل سكان الأرض، وصار الإنسان سيدا للطبيعة حاكمًا عليها؛ فلا حاجة لوصاية تفرضها السماء على الأرض، ولا حاجة للميتافيزيقا وما يأتي منها من شرائع، ذلكم هو الهاجس الهائل والدافع الكبير الذي يكمن وراء كل الأصنام التي عبدتها أوربا باسم المنهج العلميّ.
لقد توفر الدافع للانحراف بالمنهج التجريبيّ في وقت مبكر، وكان دافعًا ماديًّا شديد النزوع للمادية، لذلك كان لزامًا أن ينحو المنهج التجريبيّ هذا المنحى الذي يُعْلِي من شأن الحواسّ، فهذا “ديكارت” يجعل من الشك منهجًا ويجعل الشك في العمليات العقلية قبليًّا يطيح بمبادئ العقل الفطرية، وليس بعديًّا يفيد في اختبار النتائج، وهذا”ديفيد هيوم” يزعم أنّ الحواس هي المصدر الوحيد للحقائق.
الهوة المنهجية وآثارها
ثم تمثلت الهوة المنهجية في التنكر لأمرين، الأول: ما قبل التفكير والثاني: ما بعده، فقد أنكر المنهج التجريبيّ في نسخته الأخيرةِ الغائيةَ، وعَدَّها من الفكر الأسطوريّ الذي يرفضه المنهج العلميّ، كما أنكر مبادئ العقل الأولية، كمبدأ السببية، ومبدأ عدم التناقض وغيرها من المبادئ العقليّة الضروريّة؛ فجاءت النتائج والآثار بعد فقرة من البطر والاستكبار بأن وقع العلم المعاصر ذاته في حيرة وإبلاس؛ بسبب الاكتشافات الجديدة التي تؤدي حتمًا إلى تقويض كثير من النظريات السابقة.
وقد أدّى ذلك إلى حالة من فقدان اليقين العلميّ، هذه الحالة بدت واضحة في تصريحات الكثيرين من علماء الغرب، فهذا “أندي نول” أستاذ الأحياء في “هارفارد” يقول: “إذا أردنا تلخيص ما نعرفه عن التاريخ العميق للحياة على الأرض، عن أصل الحياة، عن مراحلها المتعددة التي أعطت فرصة لنشأة الأحياء، فإنّ علينا أن نعترف بأنّنا ننظر هنا من خلال زجاج معتم، نحن لا نعرف كيف بدأت الحياة على كوكب الأرض”، ويقول “أنطونيو لازانو”: “في الحقيقة قد لا نكون قادرين على معرفة مسيرة الحياة على الإطلاق”، ويقول السير “جون مادوكس”: “متى ثم كيف تطور التكاثر الجنسي؟ على الرغم من مرور عقود من التخمين لا نزال لا نعرف!”، ويقول “جيرالد شرويدر”: “إنّ وجود الظروف التي ساعدت على وجود الحياة لا تفسر كيف خرجت الحياة إلى الوجود”.
ويقول “ريتشارد سوينبيرن”: “وجود الكون المادي المعقد عبر زمن متناه أو لا متناه أكبر بكثير من قدرة العلم على التفسير”، ويقول “لويس ولبرت”: “لقد تعمدت تحاشي القول في نشأة العقل؛ إذ إنّنا لا نزال لا نفهم عنه شيئا”، ويقول “كارل بوبر”: “ما هي إلا خرافة علمية أن نعتقد إمكان تأمين معرفة أكيدة عن طريق معلومات نحصل عليها بالحواسّ”، ويقول “هنري أتلان”: “انقشعت ضلالات القرن العشرين؛ وجعلتنا نفهم أنّ الحقيقة العلمية هي مجرد زخرفة للحقيقة”، فإن لم تكن هذه التصريحات العلمية دليلا على حالة فقدان اليقين العلميّ العام فماذا تكون؟ فالقرآن -إِذَنْ- هو الشفاء.
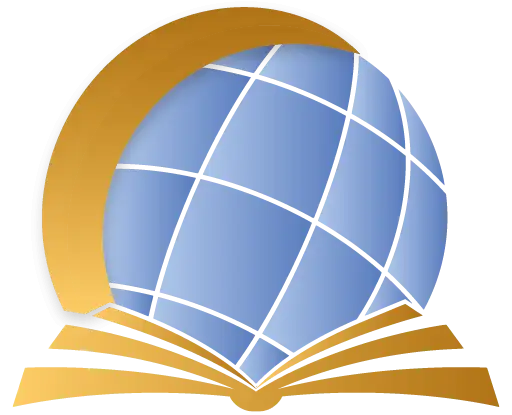


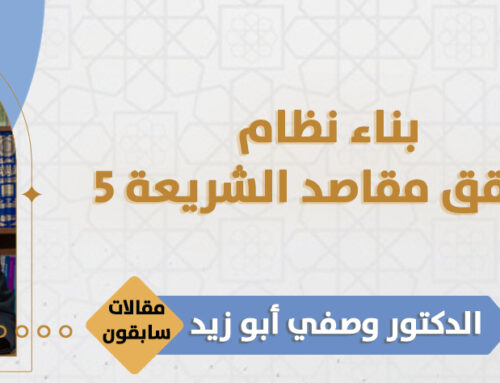








Leave A Comment